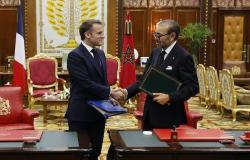نادى محمد المصباحي، المفكر والأكاديمي المغربي المتخصص في الفلسفة، بصحوة فلسفية توحد إيقاع الزمن الذي يعيشه الإنسان بالمغرب والعالم العربي مع الزمن الذي يعيشه الإنسان في العالم، في سياق تعريفه بواجبات الدرس الفلسفي في المدرسة المغربية.
كما تطرق المفكر والأكاديمي المغربي، في أحدث المحاضرات التي ألقاها تحت عنوان “واقع ومتطلبات الدرس الفلسفي” بثانوية ابن الهيثم الدار البيضاء والتي نظمها “أساتذة وأستاذات الفلسفة بالمديرية الإقليمية الحي الحسني” و”المنسقية التخصصية الجهوية لمادة الفلسفة”، إلى واجب “تعليم أو تحفيز الذهن لكي يتحرك وينتقل”، دون إغفال جوانب نضالية للتفلسف وتدريسه؛ من بينها مقاومة “جنون العقل الإرهابي الذي يمارس الشر المحض” والذي سبق أن وضح في محاضرة سابقة أن من يمثله اليوم هو إسرائيل، ومسؤولية مقاومة “جنون العقل الهوياتي الذي يبحث عن هوية مجهرية، ويجعلها كل شيء، مفتتا وحدة الكيان الوطني”، دون يعني ذلك الاشتباك الدعوي أو السياسي، بل بالحث على التفكير، تدريسا لتاريخ الفلسفة وطرائق التفلسف.
نحو صحوة فلسفية
أكد محمد المصباحي أن الفلسفة “ليست إيديولوجيا ولا عقيدة”؛ بل هي “تعليم أو حث أو تحفيز الذهن لكي يتحرك وينتقل، ويطرح أسئلة، ويراجع نفسه، لينشئ ذاته من جديد؛ وهذا هو الدرسُ الفلسفي، لا أن تكونَ ملتزما بهذا التيار الفلسفي أو بهذا المذهب أو ذاك”.
ولم يمنع هذا الأكاديمي المغربي المتخصص في الفلسفة من أن يوضح، في جزء لاحق من محاضرته، أن “للدرس الفلسفي مهمة أو جوانب نضالية؛ من بينها مقاومة جنون العقل الإرهابي الذي يمارس الشر المحض بجميع أشكاله، ونسمع في هذه الأيام يوميا كيف يمارسُ بشر.. ولا أظن أنهم يدخلون في تعريف هايدغر أو أرسطو للإنسان، (يمارسون) عملية الإبادة للإنسان والشجر والتاريخ والمستقبل والصحة وكل شيء، وجنون الإرهاب ينبغي أن نحاربه أيا كان جانبنا”.
ومما ينبغي أن يقاومه “الدرس الفلسفي” أيضا “جنون العقل الهوياتي الذي يبحث عن هوية ميكروسكوبية، ويجعلها هي كل شيء ويفتت وحدة الكيان الوطني”، وهو ما يجب أن يتم بـ”نوع من التفكيك الذي ينبغي أن يحاربه الدرس الفلسفي؛ ولكن هذه المحاربة ينبغي ألا تكون مباشرة، وإلا تحول الأستاذ إلى داعية أو سياسي، فينبغي أن يحترم الأستاذ الدرس الفلسفي ووقاره، بعدم الخوض بمسائل لا قبل له بها”. وعليه في الآن ذاته “النضال من أجل تكريس تدريس الدرس الفلسفي في العالم، والعمل على توسيع نطاقه”.
ونادى المصباحي بـ”صحوة فلسفية تجعلنا نوحد إيقاع زماننا، مع إيقاع الزمان الذي نعيش فيه، وهو الزمان الرقمي؛ صحوة تملأ قلب وعقل الإنسان المغربي والإنسان العربي، بمبادئ وقيم تجعله يتصدر المشهد العالمي”، ثم تابع قائلا: “المغاربة كانوا في ماضي الزمان يؤسسون إمبراطوريات تحكم عدة بلدان، والآن ينبغي أن نؤسس إمبراطورية فلسفية نفرض فيها، أو على الأقل نوجه من خلالها الفكر العربي لكي يستفيق ويدرك بأنه من موقعه الجغرافي، وهو البحر الأبيض المتوسط، وإطلاله على المحيط الأطلسي، بحور وقارتان (…) يتيح حقد وغضب الآخرين، الذين يحاولون بجميع الوسائل، أن يحبسونا عندما نكون قاب قوسين أو أدنى من القبض على أسرار الحداثة، والاندفاع إلى الأمام بها”.
وأكد المفكر المغربي ذاته، في درسه، أن “الحال أن الحداثة هي قدرنا، ولا نستطيع الانفكاك عنا، وهي قطار يجب أن نركبه أو يفوتنا التاريخ”.
“الأنوار الرقمية”
في ظل “الذكاء الصناعي، وشبكات التواصل الاجتماعي التي تضخ مئات المعلومات الجيدة والتافهة”، قدر المصباحي أن “واقع الأستاذ والتلميذ قد تغير، وتغيرت معه مهمة الدرس الفلسفي بكيفية جذرية؛ فهو واقع تتحكم فيه ثورات إعلامية وتواصلية إلى درجة أنها هي التي صارت تحدد عقليات وذهنيات ومشاعر وعقول وسلوك التلاميذ، وحولت غالبيتهم إلى مجرد كائنات منفعلة لا فاعلة”.
وواصل المحاضر: “توجد صعوبة تواجه أستاذ الفلسفة في تعامله مع التلميذ، الذي يميل غالبا إلى استسهال الدرس الفلسفي باللجوء أحيانا إلى وسائل الاتصال الاجتماعي والإنترنت والذكاء الاصطناعي دون القيام بأي مجهود. كما أن الأستاذ يجد صعوبة كبيرة في هذه الأيام للكلام عن الفلسفة التي صارت تتكلم عن النهايات؛ نهاية العقل ونهاية الإنسان ونهاية الحقيقة ونهاية الفلسفية، وكيف يتحدث معه وقد نبذت الفلسفة أسئلتها الأساسية: ما الوجود؟ وما الإنسان؟ وما الحقيقة؟ وهي أسئلة أصبحت وكأنها من العتاد القديم غير القابل للمداولة، وعوضتها أسئلة مثيرة ولكنها أحيانا قد تكون تافهة. وما زاد من عواصة ومأزق الدرس الفلسفي، انتشار جنون انتقاد الحداثة بمكوناتها المتعددة كالحرية والعقلانية والعلمانية، فالجميع صار ينتقد الحداثة، والحال أن الحداثة هي قدرنا”.
وتابع الأكاديمي المغربي عينه: “بعد أزمة الأصولية، نعيش اليوم أزمة الثورة الرقمية، التي أدخلتنا في كهف جديد، غير أفلاطوني، وعلى الدرس الفلسفي إخراج التلاميذ منه إلى أنوار جديدة، أنوار رقمية لا الأنوار التي كنا نعرفها، في القرن الثامن عشر مع كانط ومن جاوره، ونستفيد من غلاتها الكثيرة؛ فالثورة الرقمية نعمة من نعم الله؛ لكن مخاطرها كبيرة وكبيرة جدا، وتهدد وجود الإنسان، وتهدد كيانه، وتهدد تاريخه في هذه الأرض”.
واجبات الدرس الفلسفي
ذكر محمد المصباحي أن “الدرس الفلسفي فيما مضى كان يجمع بين واجبين متقابلين، ولكنهما متضايفان؛ أولهما تعليم الفلسفة باعتبارها تاريخ الفلسفة، وغايتها التعريف بها بوصفها منظومات من المبادئ والمناهج والنظريات والأطروحات ورؤى العالم، وهذا المفهوم هو المفهوم الهيغلي (نسبة إلى هيغل) لتعلم الفلسفة. أما ثاني الواجبين فيسعى إلى تعليم التفَلسُف، وهو تدريب التلميذ على التفلسف باعتباره تفكيرا نقديا قائما على المخاطرة العقلية، بالمعارف والبديهيات القديمة، والتطلع إلى اكتشاف أسئلة ومفاهيم جديدة وهذا هو المفهوم الكانطي (نسبة إلى كانط) لتعليم الفلسفة”.
وبين المحاضر أن “من إشكالات الأستاذ اليومية كيف يجمع بين موقف الحياد، في تقديم المعارف الفلسفية للتلاميذ، وبين حقه في تبني فلسفة معينة، أو على الأقل التعاطف معها. ولا يعنى هذا منع الأستاذ من محبة فلسفة ما، بل أن أخلاقيات التدريس تقتضي ألا يفرض فلسفة ما على تلاميذه؛ فيتحول إلى داع بدل أن يكون أستاذا”.
وتابع شارحا: “على الأستاذ أن يكون شبيها بسقراط الذي كان قبل بداية الحوار يعترف بجهله؛ أي بحياده أمام الحقيقة ليستطيع أن يولد بشكل مشترك مع محاوره، المفاهيم، أو القيم أو الأفكار التي كان يريد تعريفها”، وهذه الطريقة السقراطية تمكن “الأستاذ من تحبيب الفلسفة للتلاميذ، بإشعارهم بأنهم قادرون على المشاركة في صنع المفاهيم والآراء”.
ومن الصعوبات التي تواجه “الدرس الفلسفي”، أيضا، “الاستجابة للجديد من الفلسفات، وواجب تدريس الفلسفات الكلاسيكية؛ (…) والحكمة تقتضي الجمع بين الاختيارين المتقابلين، فلا ينبغي حرمان التلميذ من معرفة مستجدات القول الفلسفي، لكن لا ينبغي حرمانه من الأسس والركائز الأساسية للتفكير الفلسفي والتعرف على آلياته المختلفة”.
ونادى المصباحي، الذي يعد من أعلام الدرس الفلسفي بالجامعة المغربية، بـ”إغناء الدرس الفلسفي بالاستئناس بروايات الكُتّاب وقصائد الشعراء، لشحذ الدرس الفلسفي بطاقة للتواصل مع التلميذ”، مع تذكيره ببدَهية أنه “لا يُبَلغُ أطروحة، من لم يهضمها ويستوعبها بطريقة كاملة”، قبل أن يشرح نداءه السابق: “التواصل مع التلاميذ يقتضي ألا يبقى الإنسان سجين تخصصه الفلسفي، بل أن يمد يديه لكتب التصوف والأدب والشعر لتقريب المعاني إلى ذهن التلاميذ، وإيقاظ فعل الدهشة لديهم، وتحريرهم من الوثوقية وفتح سبل الإبداع عندهم”.
وأبرز المصباحي أن “واجب الدرس الفلسفي في نهاية الأمر تعريف الطالب بمجموعة من القواميس واللغات؛ لأن كل فيلسوف يتكلم بلغة خاصة، وهذه اللغات الخاصة المختلفة ربما تختلط على التلميذ، فواجب الدرس الفلسفي مجهود كبير للتبليغ، دون اللجوء إلى المصطلحات والأسئلة المعقدة؛ بل أن يلجأ الأستاذ إلى مصطلحات بسيطة، لأن التواصل أهم شيء في العملية التعليمية”.
ثم استطرد قائلا: “لا بد من الإشارة إلى أن تدفق الترجمات العديدة في العالم العربي له جوانب إيجابية؛ ولكنه أفسد عبقرية اللغة الفلسفية العربية، فالفارابي بعد جيل أو جيلين كانت لغته العربية كالمسك، وابن سينا كذلك، وابن رشد أكثرهم. إذن، كانت الفلسفة تتكلم اللغة العربية، وهذه الترجمات المفتعلة والسريعة اليوم، التي لا رقابة تحدد نطاقها، ولا وجود لقواميس أساسية لها، تفسد اللغة الفلسفية”.
وزاد: “بالنسبة لمتطلبات المنهج في الدرس الفلسفي، هناك نوعان من المناهج: المناهج التقنية التي نعلمها للطالب لكي ينجز بحثا أو يقدم عرضا أو ينجح في الامتحان، وهناك المناهج الفلسفية التي تؤدي إلى الكشف والإبداع، وهي المناهج التي يتداولها الناس؛ كالمنهج التوليدي والبرهاني والجدلي، والآن المنهج التأويلي والفينومينولوجي، لكن لا أؤمن بكثرة المناهج، وأؤمن بمنهج واحد هو منهج القلب ومنهج العقل، وهو منهج البساطة، وأن أبلغ للطالب ما أريد أن أبلغ له بشيء من التواضع، لا الشقشقة الكلامية التي تضيع الدرس الفلسفي”.